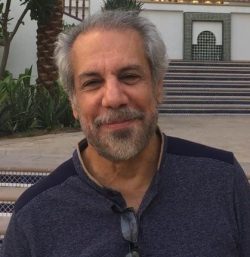مقدمة
الدراسات والكتب الحديثة التي ناقشت مسألة التأويل في الإسلام كثيرة جداً، وكانت أغلب هذه الدراسات تركز جهدها على الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة (التأويل) وعن الكيفية التي يجب فيها فهم هذه الآيات وفيما إذا كانت تضمر أو تصرح بتشريع التأويل أم تحريمه، بالإضافة إلى الاعتماد على التراث النبوي والتقاليد الإسلامية التي سمحت أو منعت التأويل. وكانت الدراسات المناصرة للتأويل التي تطمح إلى شرعنته تنحاز غالبا إلى وجهة النظر هذه أو تلك من الآراء التي تركها الأسلاف، حيث أن التأويل نفسه ينقسم إلى عدة أنواع حسب المدرسة التي اعتمدته، التأويل اللغوي أو التأويل الإشاري أو التأويل الباطني…، والتأويل الباطني نفسه له وجهان، وجه صوفي ووجه عقلاني مثّله ابن رشد.
ولكن بعيداً عن النصوص المباشرة القرآنية والنبوية، وفيما إذا كان شرعياً أم لا، فإننا نحتاج إلى قليل من النظر في بنية النص القرآني نفسه لنرى فيما إذا كان يكشف هذا النص عن ضرورة التأويل أم لا.
لقد شعرت الغالبية من الشراح المسلمين القدامى بأن هناك شيئاً ما في النص القرآني نفسه يستدعي التأويل، وقد اعتمدت هذه الغالبية على ثنائية المحكم والمتشابه، التي رأى أصحابها أنه يصعب قبول مجموعتين من الآيات يوحي ظاهرهما بعدم الاتفاق دون أي جهد إنساني في التوفيق بينهما، الأمر الذي استدعى القول إن صنفاً معيناً من هذه الآيات يجب تسميته بالمتشابه، أي غير الواضح بذاته، يجب تأويله وفق صنف آخر يبدو واضحاً بذاته يسمى محكماً. وثنائية المحكم والمتشابه هذه تم الاحتفاظ بها كمفتاح للتأويل على مدى قرون طويلة رغم التفسييرات العديدة التي أعطيت لها، من المعتزلة إلى الأشاعرة إلى ابن تيمية. ونحن نلاحظ ببساطة أن واحدة من أكبر الفرق الإسلامية في الماضي والحاضر مثل الأشاعرة مازالوا يعتبرون الآيات التي تُشّبه الله صراحة مثل الاستواء على العرش وأن لله يد وساق ووجه …هي آيات متشابهة يجب تأويلها لتصبح متفقة مع آيات التنزيه المحكمة التي تستبعد أية مشابهة بين الله وخلقه.
وذهبت مدرسة أخرى إلى قسمة النص القرآني إلى ظاهر وباطن، من أجل تقديم حلول لتلك المشكلات البنيوية التي يواجهها العقل الإنساني في فهم النص، ومن أجل الخروج بفهم إنساني نسقي ينسجم مع القرآن بوصفه نصاً إلهياً، وقد طالب ابن رشد بفهم النص فهما باطنياً يكشف عن الجانب العقلي الخفي منه.
اليوم وبعد تطور نظريات التأويل الحديثة والمعاصرة يحق لنا أن نعيد النظر في بنية النص القرآني وأن نتحرر من ثنائيات القدامى التي اعتمدوها من أجل الإجابة عن مسائل وضرورات التأويل التي يقتضيها النص ذاته. ذلك أن رفض التأويل بالمطلق واتهام أصحابه بالانحراف عن القرآن لم يعد موقفاً مقنعاً على المستوى الأكاديمي، وإن كان يسجل هذا الموقف حضوراً على المستوى العقيدي والسجال الديني اليومي.
هذا البحث هو محاولة لتجنب ثنائيات الأسلاف المذكورة أعلاه، محكم / متشابه، ظاهر / باطن، ومحاولة للبحث عن جوانب بنيوية أخرى تبرر التأويل وربما تدعونا إليه. كما لا يحاول هذا البحث أن يبرر التأويل على أساس النصوص المباشرة، ولكن على أساس العودة إلى النص والنظر فيه للبرهنة على أن التأويل أمر يقتضيه النص ذاته بالضرورة، وإذا لم يقم العقل الإنساني بهذه المهمة فإن كثيراً من المسائل تبقى عالقة أو متروكة في رؤوسنا بطريقة اعتباطية تخلو من المنطق.
ويجب علينا هنا أن نوضح نقطة أساسية وهي أن مطلب التأويل ليس رفاهية أكاديمية أو ثقافية ولكنه حاجة تاريخية للإسلام ذاته وتعبيراً صريحاً عن لا تناهي الكلام الإلهي. إذا لو افترضنا أن آيات ومفردات القرآن كانت أحادية الدلالة كما قال ابن القيم الجوزية، لكنّا حكمنا على النص الإلهي بالمحدودية وعلى نهاية كلام الله. ومن المعلوم أن كلام الله لا ينتهي وأن الله مازال يتكلم في النص ذاته الذي أريد له أن يكون آخر الكتب. هذا الكلام الإلهي اللامتناهي هو المقاصد الإلهية في النص والتي يتوجب على الإنسان التدبر فيها والبحث عنها دون توقف.
كل شيء في الإسلام مؤسس على التغير والتبدل، والثلاثية الأساسية في أي عملية تأويل ستصبح بلا معنى إذا تمسكنا بمبدأ أحادية الدلالة في قراءتنا للنص القرآني. إذ من المؤكد أن ثلاثية التأويل: النص والإنسان، والواقع، تشير بطبيعة الحال إلى التغير الدائم الذي يصيب الواقع والإنسان، وبالتالي فإن النص عندما لا يتم تدبره على هذا الأساس يصبح نصاً بعيداً عن الواقع الإنساني وهذا يناقض هدف الرسالة الإلهية الأساسي.
إن المقاصد اللامتناهية في النص تسمح للإنسان المؤول أن يتدبر النص وفق المعطيات المتجددة التي ينتجها الواقع كل يوم، وفي هذا التدبر نستطيع أن نفهم الآية القرأنية التي تقول: “قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً” (: الكهف: 18). ومن الممكن جداً هنا أن نفهم أو نفسر هذه الآية على أن كلام الله الأبدي قد تم تضمينه في النص القرآني بوصفه النص الأخير الذي يخاطب الله فيه البشر، إنه مقاصده التي تتكشف بواسطة تبدلات الواقع والتطور الثقافي الذي يعيشه الناس.
القرآن بوصفه نصاً يحيل على بعضه تأويلياً
هذا التأويل بوصفه أمانة وجودية أخذها الإنسان على عاتقه يجد أمثلته في القرآن ذاته بوصفه النص الذي يستدعي التأويل ويطرح مثاله في الوقت ذاته. وكأن القرآن يقدم لنا النماذج التأويلية الأساسية التي يمكن احتذاؤها وتوسيعها. هذه الأمثلة التأويلية في القرآن تأتي بأشكال متعددة: أحياناً على شكل أن الدلالة التعبيرية المباشرة والأولى للشيء لاتعبر بالضرورة تعبيراً صحيحاً عن حقيقته، أو مايمكن وصفه بالفارق بين القول أو الفعل المباشر وبين المقصد الحقيقي لهذا القول أو الفعل. في هذا المثال القرآني، التأويل يعنى الانتقال من مستوى تعبيري معين إلى مستوى آخر مقصود على الحقيقة ولايقدم نفسه مباشرة، بمعنى أن مدلول الشيء يحمل بعداً آخر واحتمالاً تعبيرياً آخر غير الذي ينكشف منه في الحالة الأولى، وهذا القصد الخفي الذي لا يتم التعبير عنه فوراً قد يكون هو الأكثر مطابقة لحقيقة الشيء. هذا النموذج التأويلي نجده في قصة النبي موسى والخضر.
تقول كتب التفسير أن النبي موسى ُسئل يوماً: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. و كان يصرح علناً أمام قومه أنه أعلم الناس، وذلك بعد أن زُوِد بالمعجزات وكلم الله، الأمور التي لم يحظ بها بشر مثله. عاتبه الله على هذا القول وأوحى إليه بأن هناك من هو أعلم منه، إنه ذاك الرجل الذي آتاه الله رحمة وعلّمه من لدنه علماً. فالأمر هنا بين نبي وبين رجل يحمل نوعاً آخر من العلم، والمقارنة بين العلمين تأتي من اللحظة الأولى: أيهما أعلم، هل هو النبي الذي تحدث إلى الله واستقبل كلامه وسمي بسبب ذلك “كليم الله”، أم رجلاً يتمتع بعلم من نوع آخر غير العلم النبوي؟
هذه المقارنة القرآنية بين العِلمين والرجلين كانت سبباً في قلق بعض المسلمين لأنها تصرح بوضوح أن العلم النبوي ليس حصرياً ولانموذجياً في معرفة الأشياء، بل هو علم من نوع خاص فحسب، فذهب بعضهم إلى إضافة تفسيرات لم يعلن عنها النص من أجل التخفيف من وطأة تلك المقارنة. قال بعضهم ومنهم الزمخشري إن هذا الرجل (الخضر) الذي أوحى الله لموسى أن يقابله هو أيضاً نبي، لأن الله قال في وصف هذا الرجل: “آتيناه من عندنا رحمة” والرحمة هنا هي النبوة. وبذلك فإن المقارنة تصبح بين علم نبوي وعلم نبوي آخر، الأمر الذي لاينتج عنه أي مفاضلة بين العلمين طالما أن كليهما نبويان. وذهب آخرون في اتجاه معاكس لذلك ولكن من أجل تحقيق نفس الهدف وإنقاذ العلم النبوي وجعله العلم الأول الذي لايفضله علم آخر، فقال إن موسى الوارد ذكره في الآية القرآنية ليس هو موسى بن عمران النبي، بل موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب الذي عاش قبل موسى بن عمران. وفي هذا التأويل للنص نجد أيضاً إضافة لايبررها النص ذاته. ونقلاً عن ابن عباس أن موسى الوارد في الآية هو موسى بن عمران النبي الذي جاءته التوراة، وهذا مايأخذ به عدد من المفسرين.
يقتصر الطبري والرازي وابن كثير على تفسير الرحمة بالرحمة وليس بالنبوة، ويضيف فخر الدين الرازي نقداً تفصيلياً للقائلين إن الخضر هو نبي، وهذا الرأي في اعتقاده هو رأي الأكثرية ولكنه ليس صحيحاً ويصل الرازي في نهاية هذا النقد إلى أن الخضر ليس نبياً.
وبالرغم من أن الخضر ليس نبياً إلا أن علمه أعلى درجة من علم النبي موسى بل ربما بعدة درجات، ويبدو العلم النبوي بالمقارنة مع علم الخضر علماً ضيئلاً وأقل شأناً من علم الخضر بكثير، الأمر الذي توضحه الآيات القرآنية التي تتحدث عن وضعية النبي موسى إزاء هذا العلم. فموسى يبدي استعداده لأن يسافر لملاقاة الخضر مهما بلغت المسافة التي تفصله عنه “وإذ قال موسى لفتاه لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً” (الكهف: 60)، أي حتى لو سار سنيناً أو عقوداً من السنين أو دهوراً. ثم أن موسى عندما يلاقي الخضر يبدي استعداده للانصياع التام لمطالب الخضر، هذه المطالب التي أرقّت بعض المفسرين كذلك بأن يبدو النبي في هذا الموضع من التبعية، “قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً” (الكهف: 66)، ورغم تشكيك الخضر في إمكانية موسى على انتظار المعرفة الحقيقية “وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً” (الكهف: 68)، وهذا إشارة على قلة علم موسى وخبرته، فإن موسى يؤكد استعداده لأن يتبع ويصبر دون عصيان ودون تذمر “قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً” (الكهف: 69)، فيقول الخضر: “إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً”(الكهف: 70)، ولكن موسى لايستطيع الإيفاء بوعده دائماً، لأن المعرفة الحقيقية للأشياء التي لاتبدو من التعبير الأول تحتاج إلى زمن، الأمر الذي تم التعبير عنه بمطالبة موسى بالصبر وأن لايتعجل المعرفة قبل وقتها.
هنا تبدو المعرفة التي يتمتع بها موسى بوصفه نبياً والتي أعلن أمام قومه أنها أعلى أنواع المعرفة، تبدو تابعة وناقصة وتحتاج لأن تكتمل بنوع آخر من المعرفة يتمثل في المقاصد الخفية وراء الأفعال والأقوال. إن معرفة موسى هي من النوع الحرفي التي تعتقد أن التعبير الأول عن الأشياء هو الذي يقول حقيقة الأشياء. ولكن مع ذلك فإن هذه المعرفة ليست بدون فائدة، بل هي في نهاية المطاف معرفة، نوع خاص من المعرفة إلا أنها معرفة ناقصة، لذلك يعلق الطبري على رغبة موسى في التعرف على الخضر بقوله أنه كان يريد “أن يزداد من علمه إلى علم نفسه”، أي أن يكمل علمه الذي يدل على الحقيقة ولكنه لايكشف عنها، بالعلم الذي يكشف عن الحقيقة.
يصحب الخصر موسى بن عمران معه بعد أن حصل منه على تعهد بالصبر وعدم السؤال عن الأشياء التي يراها، أو بتعبير آخر حصل منه على تعهد بأن لايجعل التعبير الأول عن الأشياء مصدراً للأحكام العقلية. يقوم الخضر بعدد من الأفعال التي لايستطيع موسى أن يفهمها أو أن يصبر ويترك الحقيقة تنكشف في الزمن حسب ماتعهد للخضر بأن يفعل. قام الخضر أولاً بخرق السفينة التي يستقلانها، ثم قام بقتل غلام صغير وجداه في رحلتهما، وأخيراً قام بإصلاح جدار مائل دون سبب ظاهر ودون أن يتقاضى عليه أجراً في الوقت الذي كانا فيه بحالة جوع شديد. في كل فعل من هذه الأفعال كان موسى يستنكر الفعل ثم يذكّره الخضر بتعهده بأن يصبر فيعتذر عن تسرعه في فهم الأمر دون انتظار الحقيقة. وفي المرة الأخيرة يعلن الخضر نفاذ صبره مع موسى الذي خرق تعهده عدة مرات فيقول له: “هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً” (الكهف: 78). ثم يخبره بتأويل تلك الأفعال. فالخضر قد خرق السفينة من أجل أن يعيبها ويلحق بها ضرراً كي يحميها من ضرر أكبر هو احتمال اغتصابها من الملك. ثم أنه قتل الغلام لأن في بقائه مفسدة لوالديه في دينهم ودنياهم. وأخيراً قام بإصلاح الجدار وبذل جهداً في ذلك دون أن يتقاضى أجراً لأن هذا الجدار يقوم على كنز مطمور أسفله هو إرث لطفلين صغيرين بانتظار أن يكبرا ويحصلا عليه.
كان موسى يعتقد في كل مرة أن التعبير الأول عن الشيء هو حقيقة ذلك الشيء ويصدر حكماً ينكر فيه هذه (الحقيقة)، ولكن كان في كل مرة يخطىء في اعتقاده هذا، ثم يكرر رد فعله اتجاه المعرفة مرة ثانية. إن مايفسر هذا التكرار ثم الاعتذار رغم التعهد بالصبر هو أن نمط معرفة موسى للأشياء نمط ثابت يصعب اختراقه وتوسيعه، وهذا ماجعل الخضر يعلن الفراق بينهما.
يعلق الرازي على ذلك بالقول:
“ان أحكام الأنبياء صلوات الله عليهم مبنية على الظواهر كما قال عليه السلام: (نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) وهذا العالم (الخضر) ماكانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور بل كانت مبنية على الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمر، …..وفي هذه المسائل الثلاثة ليس حكم ذلك العالم فيها مبنياً عن الأسباب الظاهرة المعلومة، بل كان ذلك الحكم مبنياً على أسباب معتبرة في نفس الأمر، وهذا يدل على أن ذلك العالِم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حقائق الأشياء فكانت مرتبة موسى عليه السلام في معرفة الشرائع والأحكام بناء الأمر على الظواهر وهذا العالِم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائق الأمور والإطلاع على أسرارها الكامنة، فبهذا الطريق ظهر أن مرتبته في العلم فوق مرتبة موسى عليه السلام.”
في هذا المثال يقدم لنا القرآن نموذجاً صريحاً من نماذج التأويل ويقر بنوعين من المعرفة، ظاهرية، و شكلاً آخر من أشكال المعرفة تكشف عن القصد الحقيقي من الأشياء، إنه شكل أعمق لايكشف عن نفسه في التعبير الأول والحرفي، في حين أن شكل المعرفة الآخر الأعمق والمطابق للحقيقة هو شكل من المعرفة يمتلكه أناس ليسوا أنبياء، بل بشر يتمتعون بالقدرة العقلية والملكات الإدراكية الطبيعية في الكشف عن الحقائق في الزمن، وهذا يؤكد مرة أخرى على العلاقة بين النص القدسي وبين البشر في التاريخ. فإذا كان النبي يتلقى الرسالة فإن الجماعة بوصفها إطاراً لنشاط الأفراد المتعدد الاتجاهات هي من يكشف عن حقائق هذه الرسالة.
هذا النموذج من التأويل القرآني هو ما اعتبره المسلمون مصدراً لثنائية الظاهر والباطن التي تبنتها أكثر من مدرسة، ولكن هذه المدارس فهمت من نموذج الخضر شخصية استثنائية في فهم الباطن. فهو إما إمام أو عارف صوفي أو فيلسوف، ولكننا نستطيع أن نضيف اليوم (الجماعة) باعتبارها المعني الأول في معرفة المقاصد الخفية في الدلالات القرآنية المباشرة.
النماذج التأويلية الرمزية
النموذج التأويلي الثاني الذي يقدمه القرآن هو النموذج الرمزي. وهذا النموذج يأخذ في القرآن ثلاثة أنماط، في كل واحد منها تلعب الصيغة الرمزية دوراً مختلفاً وتقتضي تأويلاً مختلفاً، ولكن كل هذه الأنماط تقوم على مبدأ أساس هو التعدد التعبيري لقول موضوع واحد:
في النمط الأول من أنماط التأويل الرمزي، نجد النص يقدم للموضوع الواحد صيغتين تعبيريتين، صيغة رمزية وصيغة غير رمزية. ومثال هذا النمط هو مسألة الشر ومترادفاتها من الذنب والمعصية والفواحش وسوء السبيل..،. هنا يجد قارىء النص أنه من الضروري إحالة اللغة الرمزية إلى اللغة الأخرى كي يتسق فهمه للموضوع، وهذه الإحالة هي مانقصده بالنمط الأول من أنماط التأويل.
النمط الثاني من أنماط اللغة الرمزية هو التعبير عن الموضوع بصيغ لغوية متعددة دون حسم وتحديد النمط الذي يجب الإحالة إليه. والمقصود هنا مسألة الخلق التي يتم التعبير عنها بأكثر من صيغة واحدة، دون تقديم تعيين ثابت ونهائي لهذه الصيغ، بخلاف الصيغة الأولى، الأمر الذي يفترض نمطاً آخر من أنماط التأويل لاتحيل فيه صيغة على أخرى بل يدعو تعدد الصيغ ذاك إلى تأويلها بشكل مفتوح.
النمط الثالث من أنماط اللغة الرمزية هو تقديم تمثيلات متعددة لموضوع لايمكن ضبطه مفهومياً ونهائياً. وهذا يجعل من اللغة الرمزية لغة مقاربة وليست لغة تعيين وتحديد. ولكن طالما أن الموضوع الذي تقاربه اللغة الرمزية غير قابل للتحديد فإن هذه اللغة التمثلية الرمزية تقدم لنا مداخل يمكن تأويلها على أنها مفتوحة من أجل ممارسة الأمر نفسه وهو مقاربة الموضوع غير القابل للتحديد. والمثال هنا هو الأمثلة التي تحدث بها الله عن نفسه، فهي مجرد تمثيلات ورموز تساعد الفهم الإنساني على مقاربة الله، ولكن الله بذاته لايمكن ضبطه بماهيم ثابتة ونهائية. وهنا تصبح عملية التأويل ممارسة للجهد الإنساني من أجل فهم الله بصيغ متعددة دون أن يدعي هذا الوعي أنه استنفذ الأمر نهائياً بأي صيغه.
في العودة للنمط الأول، النمط الذي يتم التعبير فيه عن موضوع واحد بأكثر من لغة واحدة، مرة لغة رمزية ومرة غير رمزية، نجد التعبيرات القرآنية عن الشر تندرج في هذا النمط.
إن مسألة الشر وكل المفردات المرادفة له من ذنب ومعصية وفاحشة وضلال نجدها قد وردت في القرآن بصيغ متعددة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصدر الشر أو الفاعل له. هذه الصيغ لا تشكل لو أخذت بشكل حرفي أي تصور موحد أو متسق عن مفهوم الشر، ولا تترك في ذهن المؤمن فهماً واضحاً عن المسؤول الحقيقي عن فعل الشر.
إن الله بوصفه مصدراً للعالم كله هو مصدر غير مباشر للشر بطبيعة الحال، والإنسان هو الفاعل الأكيد للشر كذلك، والشيطان أيضاً هو دافع الشر بامتياز، الأمر الذي يطرح علينا بكل تأكيد سؤالاً مهماً يتعلق بفعل الشر ذاته، وبالأدوار التي تتوزع على هذه الأقطاب في فعله.
إن المؤمن الذي يتلقى من القرآن هذه الصيغ المتعددة لا يستطيع أن يحسم بدقة مسؤولية فعل الشر الذي يصدر عنه. هل يتحمل المؤمن مسؤولية الشر الذي يصدر عنه من ذنب أو معصية أو فاحشة بشكل تام، أم أن الشيطان يلعب دور الشريك الأساسي في هذا الفعل؟ وهل صدور فعل الشر عنه قد تم بإرادة الله أم بغياب تام عنها؟ لذلك نرى المؤمن في فعله الأخلاقي موزعاً بين بذل الجهد لإبعاد الشيطان الذي يبدو أنه يتحمل المسؤولية الأكبر بالنسبة له، وبين طلب العون الدائم من الله أن لايضله ولايجعله تائهاً في أفعاله. الأمر الذي يؤدي في النتيجة لأن يكون الفعل الأخلاقي فعلاً مستنداً على التأثير على القوى الخارجة عن الإنسان أكثر من كونه فعلاً يصدر عن الذات صدوراً تاماً.
إننا في مسألة الشر بالتحديد أمام وجه من وجوه النص القرآني الذي يشير لنا بوضوح إلى ضرورة ممارسة التأويل إذا أردنا أن نفهم المقصد الإلهي من هذا الأمر. إن ترك الأمور على حالها، بين القول إن الله مصدر كل شيء، وبين الاعتراف بدور الشيطان فيه وكذلك بدور الفعل الإنساني لايفيد المؤمن شيئاً ولا يفسر وضعيته كفاعل أخلاقي، لأنه بهذه الحالة يصبح كفاعل إنساني رهينة قوى أخرى غير ذاته أكثر من كونه فاعلاً أخلاقياً مركزياً لأفعاله.
خصوصية هذه المسألة في القرآن أنها تطرح على العقل الإنساني حالة للتفكير حيث يصبح من الضروري للمؤمن أن يحيل نصوصاً على أخرى. إنه نموذج للتأويل يحتل فيه القرآن دور إعلان الموقف ودور المرجعية في فهمه. فالنصوص القرآنية يحيل بعضها على بعض وتؤول إحداها الأخرى، وتصبح صيغة تعبيرية معينة مرجعية لصيغة تعبيرية أخرى. ولا بد من التأكيد هنا على أن أية محاولة لفهم الصيغ المتعددة التي ترد في القرآن حول مسألة بعينها هو فهم تأويلي. ومهما اعتقد البعض بأنه يفسر فقط فإنه في الحقيقة يؤول. إن التفسير في إطار التعدد التعبيري عن شيء واحد هو تأويل بامتياز، لأن هذا التفسير بالضرورة سيعتمد معياراً واحداً في عملية ضبط تعدد الصيغ تلك من أجل فهمها. ويصبح كل وجه من وجوه التفسير يحتمل عكسه، فإذا شدّد أحدهم على دور الشيطان وأرجع مايصدر عن الفعل الإنساني إلى الشيطان فإنه يؤول، وإذا فعل ثان العكس وأكد على دور الإنسان وأرجع فعل الشيطان إلى محض فعلٍ إنساني فهو يؤول، وإذا ذهب ثالث إلى نزع الفاعلية عن الإنسان والشيطان معاً وأرجع كل شيء إلى الفعل الإلهي المطلق والشامل فإنه كذلك يؤول، وإذا ذهب رابع إلى ادعاء الالتزام الحرفي بالنص ووزع مسؤولية فعل الشر على كل الأطراف بدعوى أن لكل دوره في الفعل فإنه يؤول.
إن تاريخ الممارسة الفكرية الإسلامية يكشف عن هذا الأمر بوضوح شديد حيث يظهر تعدد المدارس العقدية على أنه تعدد لأشكال الفهم حول تأويل توزيع المسؤولية في الفعل الأخلاقي. هناك من أكد على الدور الإنساني في الفعل (القدرية)، وهناك من شدّد على شمول الخلق والفاعلية الإلهية (الجبرية)، وهناك من اختط طريقاً وسطاً بين شمول الفعل الإلهي وبين الاعتراف بدرجة ما من درجات الفعل الإنساني (نظرية الكسب)، وهناك من اعتمد أسساً فلسفية في تفسير الشر في العالم وطبيعة الفعل الإنساني كالفلاسفة وابن تيمية. وفي كل الحالات فإنه لايمكن اعتبار أي من هذه الصيغ نهائية من زاوية مطابقتها للنص، لأن النص ذاته جعل من الممكن تعدد الصيغ.
لقد جاءت مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية تصرح بأن الأفعال التي تنتسب للشر يمكن أن يقوم بها الله، خصوصاً فعل الإضلال وكذلك الفتنه والابتلاء، فالآية التي تنص على “الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ” (الزمر: 23) تحصر فعلي الهداية والإضلال بإرادة الله فقط، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات اللاهوتية حول مصير الإنسان. لذلك يبدو أنه من غير الممكن أن نأخذ هذه الآيات القرآنية على حرفيتنها ونعتبر أن كل فعل إضلال يصيب الإنسان مصدره من الله، لأن هذا الفهم الذي توحي به الآية إيحاءً مباشراً يُفرط بمعنى الوجود الإنساني وتصبح مسألة الخلق كلها لا مبرر لها. وهنا لا بد من القول إن مصدرية الله لكل شيء تعني أن الله خلق كل شيء بوصفه ممكناً فحسب، بوصفه وجوداً محتملاً يحيل دائماً إلى شيء آخر، لا على أنه وجود نهائي وناجز. ومن هذه الفرضية فإن العالَم بوصفه جملة ممكنات لن تتحدد مصائره ولا مصائر الأشياء المفردة فيه إلا من خلال دخول هذه الأشياء بعلاقات متبادلة فيما بينها بما في ذلك الإنسان. إن الشيء بذاته كما هو موجود لايوصف بأنه خير أو شر (نحن هنا بصدد الحديث عن المسألة الأخلاقية)، ولا يصبح الشيء على حال معينة إلا عندما يدخل في علاقة مع شيء آخر، عندها يتحقق هذا الممكن على صورة معينة. بكلمات أخرى، فإن الله قد أوجد الأشياء بذاتها ولكن العلاقات المتبادلة التي تدخل فيها الأشياء مع بعضها هي التي تنقل الأشياء من كونها (في ذاتها) إلى أن تكون (من أجل) شيء آخر. ورغم الاختلاف بين الكونين، كون الشيء في ذاته وكونه لأجل شيء آخر، فإن الحالتين تتصلان ببعضهما اتصالاً جوهرياً.
إن الآيات القرآنية التي تشير إلى مصدرية الله في فعل كل شيء بما في ذلك الإضلال، يمكن فهمها بشكل أفضل من هذه الزاوية. يقول الله: “كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة” (الأنبياء: 35)، فابتلاء الله للإنسان بالخير والشر هو بمعنى آخر ابتلاء له بالوجود كله، ولايمكن فهم الخيار الإنساني هنا إلا من خلال الابتلاء الذي يعني كيفية دخول الإنسان بعلاقة مع الأشياء، وبالكيفية التي يعقد فيها صلاته مع العالم بلونيه الأساسيين، الخير والشر. وهنا تماماً تقع فكرة الفتنة بوصفها ذلك الاحتمال من العلاقات غير السوية مع هذا العالم. إن الآية تطرح خياراً واضحاً يتعلق بنمط إنشاء العلاقات مع العالم، والفتنة ليست إلا دعوة لإيقاظ انتباه الإنسان في لحظة بنائه لتلك العلاقات وبضرورة أن يتحرى اختياراته جيداً في عملية تحويل الأشياء من (بذاتها) لتكون (من أجله). ويبدو ربط الموت بهذا الابتلاء وهذه الفتنة ربطاً مهماً يذكر بالمصير النهائي الذي يأتي إما إكمالاً وتتويجاً لفعل إنساني إيجابي أو نهاية مأساوية له تتبع نمط تحويل الأشياء وتحقيقها.
كذلك الآية القرآنية: “إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملاً” (الكهف: 7) هي أيضاً آية صريحة في حديثها عن الإثارة التي يمثلها العالم (الأرض) ويغوي فيها الإنسان بوصفه عالماً ممكناً فحسب يحرض الإنسان على الفعل، فعل شيء ما حياله من أجل تحويله من وضعية إلى أخرى، من أجل تحقيقه بصورة دون أخرى.
في هذا السياق يمكن فهم فعل الإضلال الذي يقوم به الله. إن الآية التي تقول: “فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء” (فاطر: 35) لايمكن فهمها بمعنى تحكمي غير قابل للتفسير، بل من الممكن فهمها من خلال مبدأ سببي يكشف عن طبيعة العلاقة بين الفعل الإنساني وبين الإضلال الإلهي. أي يجب فهمهما من خلال ردها إلى الدور الإنساني بوصفه دوراً محولاً للأشياء. ويتضح الأمر أكثر بالآية التي تقول: “كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب” (غافر: 34)، فالله لايضل من يشاء بتحكمية تلغي مبرر الوجود الإنساني، بل يضل من قد أضل نفسه أولاً، أو من قام بأفعال تبرر فعل الإضلال. فالفعل الإنساني هو الأول والقرار الإلهي ناتج عن الفعل الإنساني الذي صدر عنه بمسؤولية خاصة به.
إن الله لايضل من عمل صالحاً ولا يضل المؤمن بل “يضل الله الكافرين” (غافر: 74)، فالإضلال الإلهي يأتي في نفس الاتجاه الذي رسمه الإنسان لنفسه وليس معاكساً له، لأن الإرادة الإلهية لاتأتي ضداً على طبيعة الأشياء، فإن كان الإنسان قد اتخذ قراراً بالكفر فإن الله إذن سيضله، وإذا كان قد اتخذ قراراً بالهدى فإن الله سيهديه. “وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون” (آل عمران: 69)، “من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها” (الإسراء: 15 & الزمر: 41 & سبأ: 50). إن الأمر برمته هو مسؤولية الإنسان ورهن إرادته، هذه الإرادة متى ذهبت في اتجاه فإنها تكون قد قررت مصيرها وفق هذا الاتجاه، وبعد ذلك يعلن الله قراره بإضلاله أو هديه. وبطبيعة الحال فإنه قرار قابل للاستئناف في كل لحظة، إذ أن من رسم مصيراً لنفسه يمكن أن يرتد عنه، وعندها يعود إلى رسم مصير آخر، وتأتي إرادة الله مسايرة للفعل الإنساني، “قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب” (الرعد: 27).
إن المصير الإنساني شيء يتقرر داخل المملكة الإنسانية ذاتها، هذه المملكة هي التي تنشىء توجهاتها وميولها وطريقة فهمهما للعالم وأسلوب تحويلها للأشياء، ولكن لأن الأمور لايمكن حصرها ضمن أطرها الجزئية مرتبطة بهذا الفعل المفرد أو ذاك كان لابد من صيغة تجعل للأفعال الجزئية توجهاً عاماً وقراراً كونياً، وهنا تأتي إرادة الله بوصفها ذلك التوجه الكلي الذي ترسمه أفعال الأفراد وتجعل منه مصيراً عاماً.
وبالطريقة ذاتها التي يمكن فيها تأويل تعدد الصيغ القرآنية حول دور الإنسان ودور الله في الفعل نفسه، كذلك لابد من ممارسة الفهم ذاته على الأدوار التي يتوزعها الشيطان والإنسان في فعل الشر. وهنا أيضاَ تبدو الصيغ القرآنية متعددة وتلح على المؤمن أن يؤولها بالضرورة.
يأتي صدور أفعال الشر من ذنوب ومعاص وفواحش بصيغتين اثنتين بالقرآن، واحدة تجعل من الشيطان مسؤولاً عن دفع الإنسان لارتكابها، وأخرى تظهر الإنسان على أنه الفاعل الوحيد لها. ولا ينفع هنا اللجوء إلى أسلوب توزيع المسؤولية بطريقة إنشائية آلية لاتفسر الأمر بقدر ماتكرره بصيغة أخرى.
لقد جاءت الأفعال الشيطانية في القرآن بصيغ متعددة مثل:
يغوي (الأعراف: 175)، ويأمر بالفحشاء (النور: 21 & البقرة: 268)، ويتخبط الإنسان (البقرة: 275)، ويخوّف (النساء: 60)، ويكيد (النساء: 76)، ويوقع العداوة (المائدة: 91)، ويفتن (الأعراف: 27)، ويزين (الأنفال: 48)، ويوسوس (طه: 120)، ويُحزن (المجادلة: 10)، ويوحي (الأنعام: 121)، ويستحوذ على الإنسان (المجادلة: 19)، ويزل (البقرة: 36) ويعد بالفقر (البقرة: 268)، وينزغ (الأعراف: 200 & فصلت: 36)، ويضل (القصص: 15).
إن هذه الأفعال التي تنسب للشيطان تتسم كما هو واضح بسمتين أساسيتين، أولاً تعلقها بالإنسان وحده فحسب، أي أنها ليست أفعالاً كونية ترسم مصائر نهائية للفرد كما هو الشأن في الإرادة الإلهية. وثانياً، أنها أفعال ذات اتجاه واحد، هو الشر. هاتان الصيغتان الواضحتان من القرآن تسهلان الدعوة للتأويل، لتأويل الفعل الشيطاني بأنه في الأصل هو فعل إنساني وليس شيئاً آخر. نلاحظ أننا لو قمنا بإزاحة هذه الأفعال من الشيطان إلى الإنسان لما تغير شيء. إن أفعال التزيين والإغواء والإضلال والوسوسة والاستحواذ والافتتان والتخبط والكيد والتخويف والإيحاء والحزن والزلل..، كلها أفعال يمكن ببساطة نسبتها إلى النفس الإنسانية، إنها بمعنى آخر هي ذاتها أفعال النفس الإنسانية. والقرآن ذاته يؤكد هذا الأمر حين ينسب هذه الأفعال إلى الإنسان ذاته. ينص القرآن بصيغة واضحة أن النفس الإنسانية ليست بريئة أصلاً من نوازع الشر، فالشر شيء موجود فيها بالطبيعة، “ونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها” (الشمس: 8)، الفجور بوصفه شراً هو إلهام إلهي يقف على نفس مستوى التقوى التي هي خير في النفس الإنسانية. فالله إذن لايلهم النفس الإنسانية التقوى ويترك للشيطان أمر فجور هذه النفس، بل كلاهما قائمان منذ البدء في النفس الإنسانية، وكلاهما يتمتع بموضع مساوٍ للآخر. وكلمة إلهام هنا تتيح المجال للقول إنهما مجرد إمكانيتان يتصرف بهما الإنسان ويخرجهما وفق مشيئته هو. ولذلك نجد بقية الآية تحيل أمر هذا التصرف بالتقوى والفجور إلى الذات الإنسانية فقط بوصفها المسؤول الوحيد عن أفعالها: “قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها” (الشمس: 9).
يؤكد القرآن هذا المعنى المتصل بالمسؤولية الذاتية للفعل الإنساني بموضع آخر في قصة آدم الذي قال له الله “ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين” (البقرة: 35)، “فأزلهما الشيطان عنها” (البقرة: 36)، وفي سورة الأعراف 20: “فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ماووري عنهما من سوءاتهما وقال مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين”.
فالشيطان هو الذي “أزلهما” وهو الذي “وسوس” لهما، الأمر الذي يمنحهما بعض العذر لجهلهما بكل شيء حولهما، ولكن إجابة آدم على عتب الله تلغي الشيطان كلية من المشهد، فيقولان: “ربنا ظلمنا أنفسنا” دون تقديم أي عذر يُحمِّل الشيطان مسؤولية الفعل الذي قاما به، إن فعلهما هو مسؤوليتهما فحسب.
والموقف ذاته يتكرر مع النبي موسى الذي يرتكب فعل القتل والذي يعبر القرآن عن مسؤولية هذا الفعل المذموم بصيغتين، واحدة تحمل الشيطان مسؤوليته وواحدة تحمل الفاعل الإنساني وحده هذه المسؤولية. “ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم” (البقرة: 16-15). إن هاتين الصيغتين لايمكن التوفيق بينهما إلا بشكل ما من أشكال التأويل، فالفعل الشرير هو تارة من عمل الشيطان وتارة من عمل النفس، ولايمكن هنا البحث عن صيغة توفيقية بين الصيغتين كالقول مثلاً أن دور الشيطان هو مجرد دور الوسوسة والإغواء والفتنة وإن النفس هي المسؤولة عن الاستسلام وقبول هذا الإغواء وهذه الوسوسة أم لا. إن هذا الميل نحو التوفيق يصبح لامعنى له عندما نرى أن القرآن ينسب هذه الأفعال ذاتها للإنسان أو الله أو الأشياء، فالنفس توسوس أي أن هذا الفعل ليس خاصاً بالشيطان فقط: “ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه” (ق: 16) والنفس تغوي “وعصى آدم ربه فغوى” (طه: 121) والله يزين “زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين” (آل عمران: 14)، و”أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء” (فاطر: 8)، والله يفتن، ” فمن يرد الله فتنته فلن تملك له شيئاً” (المائدة: 41)، والأموال والأولاد فاتنة أيضاً “واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة” (الأنفال: 28). وبالتالي يعود السؤال مرة أخرى حول فيما إذا كان الشيطان هو كائن موضوعي يحتكر هذه الأفعال لوحده أم أنه هو نفسه ذلك النازع الإنساني القابع في الذات والذي يجمح أحياناً طلباً للتلبية والتحقق.
إن القرآن ذاته يقرر ” إن النفس لأمارة بالسوء” (يوسف: 53)، فالشيطان الذي يأمر بالفحشاء كما ورد في سورة النور، 21 وسورة البقرة، 268، أنه هو ذاته النفس التي تجمح إحدى دوافعها على التحقق بأشكال منفلتة.
إن الإنسان هو صاحب الحمولة الأخلاقية الوحيد وهو مصدر الفعل الأخلاقي والمسؤول عنه، ولايمكن فهم الشيطان إلا بوصفه إحدى دوافع النفس أو هواها أو ميولها الغريزية أو التدميرية. وكل الآيات التي تصف الإنسان وتتحدث عنه تؤكد أن هذه الآيات هي المرجعية في تأويل الشيطان، لأنه بدون هذا التأويل ستبدو مسؤولية الفعل الأخلاقي دون ارتكاز مصدري واضح، وهو أمر لايتفق مع مبدأ محاسبة الإنسان على أفعاله الذي يظهره القرآن أيضاً على أنه المسؤول الوحيد عن تلك الأفعال. “بل الإنسان على نفسه بصيرة” )القيامة: 14)، “وأن ليس للإنسان إلا ماسعى” )لنجم: 39(، “قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي” (سبأ: 50)، “فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها” (يونس: 108).
إن الطبيعة الإنسانية كما يصورها القرآن تتضمن بامتياز كل احتمالات الشر، فالإنسان كائن معقد تتجمع فيه العناصر والدوافع التي تجعله فاعلاً للشر، وبالوقت ذاته مقاوماً للشر وفاعلاً للخير. فالإنسان “خلق عجولاً” (الإسراء: 11)، و”كان الإنسان قتوراً” (الإسراء: 100)، بخيلاً، والإنسان يطغى (العلق: 6)، وهو مغرور (الانفطار: 6)، و كفور (الحج: 66)، وجهول (الأحزاب: 72)، وهلوع خائف (المعارج: 19)، وكنود جاحد (العاديات: 6)، وظلوم (إبراهيم: 34).
إن كل ذلك يقدم نموذجاً تأويلياً يكون فيه القرآن هو مرجعية ذاته، فالشيطان هو أحد وجوه الطبيعة الإنسانية الملازمة له، إنه هو ماتم تصويره على أنه قرين الإنسان (ق: 23 & فصلت: 25) أو هو أحد قرنائه الذي يلازمه بوصفه ليس سوى طبيعته الخاصة فحسب.
إن الفكر الثيولوجي الإسلامي في محاولته صياغة موقف من الفعل الإنساني وتحديد مسألة الشر، نراه يلغي الاعتراف بالشيطان تماماً وتتوقف مصطلحات هذا الفكر عند علاقة الاستطاعة الإنسانية بالقدرة الكلية لله وبشمول هذه القدرة لكل شيء. إن نظريات الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ونظرية ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الفعل الإنساني، كلها مارست تأويلاً ضمنياً على فكرة الشيطان، واقتصر البحث الأخلاقي عندها على صياغة مفهوم للفاعل، الأمر الذي جعل نظرية الفعل تتوزع عندهم على قطبين فقط: الله والإنسان. كانت الجهود التأويلية تتجه نحو تحديد مسؤولية الإنسان بوصفه كائناً فاعلاً للخير والشر. وكان هذا الفكر منذ بداياته حتى نظرياته المتأخرة قد مارس تأويلاً أكيداً على فكرة الشيطان من خلال إزاحته من البحث الأخلاقي والاقتصار في البحث على طبيعة القدرة الإنسانية فحسب. أما ابن عربي (ت. 638) فإنه يعلن تأويله صراحة للشيطان، وتأويله يأخذ عدة معان حسب سياق الآية كما يفهمها هو، فمرة يكون الشيطان هو القوى النفسية الملازمة للجهة السفلية الدائمة الهوان بملازمة الأبدان. ومرة هو الوهم.
النموذج التأويلي الرمزي الثاني ومسألة الخلق
لقد قدمت مسألة الفعل الإنساني أو مسألة صدور الشر عن الإنسان التي وردت في القرآن نموذجاً تأويلياً محدداً يؤول فيه القرآن ذاته. فالشيطان ليس سوى النفس الأمارة بالسوء وهو الفجور الذي ألهمه الله للنفس، وأن أفعال الشيطان هي ذاتها أفعال النفس الجامحة التي تزين وتوسوس وتغوي وتستحوذ على النفس..,. أو هي عنصر إغواء خارجي يتمثل في الدنيا والنساء والبنين والمال.
ولكن في مسألة الخلق يقدم القرآن نمطاً مختلفاً من أنماط التأويل، حيث تتعدد أشكال التعبير عن موضوع الخلق وفق صيغتين أساسيتين، واحدة منهما صيغة عامة بدون تعيين والثانية تأتي كصيغ تعيينية متعددة للصيغة العامة الأولى.
إن مفهوم الخلق وكل المترادفات اللفظية الأخرى المرتبطة به من الجعل والتقدير والصنع والأمر جاءت بصيغ تعبيرية متعددة بما يبرر كفاية ممارسة التأويل في هذا الأمر. إن النمط التأويلي الذي يقدم القرآن نموذجه هنا هو أن هناك صيغة عامة للخلق غير مفسرة بذاتها وهناك من جهة أخرى تعيينات وتحديدات يقدمها القرآن من أجل جعلها مفسرة ومفهومة. يقدم القرآن عدة صيغ تعبيرية من أجل تعيين الصيغة العامة الأولى. ولكن هذه الصيغ التعبيرية التي تقصد تحديد مفهوم الخلق العام لاتقدم إجابة حاسمة، بل هي أقرب لأن تكون غير متفقة فيما بينها وهذا أمر لايقدم إجابة نهائية عن صورة الخلق، الأمر الذي يقتضي تأويل مايجب أن يكون شكلاً تعيينياً لصيغة الخلق العامة. بالمقارنة مع فكرة الشيطان وصدور الشر عن الإنسان فقد كان القرآن حاسماً في مسألة الفعل الإنساني ووفر كل المرجعيات الممكنة لتأويل الشيطان، ولكن في مسألة الخلق لانجد هذه الصيغة المماثلة، الأمر الذي يفتح للمؤول باب الاجتهاد في البحث عن صيغ تعيينية للخلق، وهو أمر يبدو أن القرآن أجازه من خلال تقديم صور تعين مفهوم الخلق بطرق متعددة إلى حد التباعد.
إن الصيغة العامة التي جاء بها القرآن في مسألة الخلق هي تلك المفاهيم العامة غير المحددة والتي لاتفسر كيفية إيجاد الله للعالم، ولكنها تقرره فقط، مثل، القدرة، المشيئة، لفظة الخلق ذاتها، مثل: “يخلق الله مايشاء، إن الله على كل شيء قدير” (النور: 45)، “أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم” (الإسراء: 99)، “أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم” (يس: 81).
ولكن أكثر الألفاظ استعمالاً في مسألة إيجاد الله للعالم هي لفظة الخلق، هذه اللفظة التي تُعد من أكثر الألفاظ تكراراً في القرآن، “اقرأ باسم ربك الذي خلق” (العلق: 1)، “والله خلقكم ثم يتوفاكم” (النحل: 70)، “ماخلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق” (الأحقاف: 3)،…..،. ولكن هذه الألفاظ العامة تحتاج إلى تعيين وتحديد من أجل تفسيرها، لأن ألفاظ الخلق والقدرة والصنع والجعل هي من الألفاظ العامة، التي إن بقيت على حالها فإنها لاتتجاوز حدود إقرار الأمر دون أن تفسر كيفيته. وهذا مايذهب إليه القرآن في آيات أخرى من أجل تحديد وتعيين عملية الخلق التي تنقل اللفظ من عموميته إلى تعيناته المحددة.
إن طبيعة الآيات التي تحدد الكيفية التي تم بها الخلق تجعل من الممكن القيام بالتأويل، بل إنها أكثر من ذلك تدعو بإلحاح إليه. في صيغة من الصيغ يقول الله أن الخلق يحصل باليدين: “قال يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي” (ص: 75)، وفي مكان آخر: “أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون” (يس: 71)؛ ولكن في صيغة أخرى نجد أن الله يخلق بالكلمة: “إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون” (النحل: 40 & يس: 82)، وهما صيغتان: اليد والكلمة مختلفتان. أيضاً في تفسير عملية الخلق نجد عدداً من الآيات تصور الخلق على أنه تدريجي ويتم مرحلة بعد مرحلة، “ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم” (الكهف: 48)، وكما نلاحظ هنا يصعب التمييز كثيراً بين الكيفية التي خلق بها آدم بوصفه الإنسان الأول وبين خلق الإنسان بشكل عام ونلاحظ كيف تبتدئ الآية بصيغة الجمع، أي البشر، ثم تحدد هذا الجمع بآدم. وفي موضع آخر يشير القرآن إلى الخلق بوصفه تسلسلاً: “فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين” (الحجر: 29). وسواء كان المقصود آدم كإنسان أول فرد أم الإنسان عامة فإن الخلق يتم تفسيره هنا على أنه يتم على مراحل، التسوية ثم النفح في الروح، أو الخلق ثم التصوير، رغم تقارب المعنيين بين الخلق والتصوير. وهذا الخلق المتدرج إلى مراحل يتكرر ذكره كوصف للخلق في آيات أخرى تتحدث عن خلق الإنسان، مثل: “وقد خلقكم أطواراً” (نوح: 14)، وكذلك “ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين” (المؤمنون: 12)، “والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً” (فاطر: 11)، “هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة” (غافر: 67).
وهذا الخلق المتدرج لاينطبق فقط على الإنسان بل هو ذاته طريقة خلق العالم “ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام” (ق: 38 & يونس: 3 & الفرقان: 59 & السجدة: 4 & الحديد: 4)، “قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين….وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين” (فصلت: 9)، “فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها” (فصلت: 12)، “ثم استوى إلى السماء وهي دخان” (فصلت: 11) أي بخار مرتفع.
هذا الخلق التدريجي يقابله خلق فوري يتم بالكلمة فقط بوصف هذه الخلق حسب البعض هو الأكثر اتفاقا مع القدرة الإلهية المطلقة، مثل: “إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون” (آل عمران: 59 & مريم: 35 & غافر: 68).
إن هذا التعدد في تعيين مفهوم الخلق وكيفية حدوثه بين الخلق بالكلمة أو الخلق باليد، والخلق التدريجي أو الفوري، هو ما جعل الممارسة التاريخية للفكر الإسلامي تذهب في تأويل الخلق الإلهي للعالم في اتجاهات متعددة، وهي تستند أساساً إلى التنويع القرآني في هذا الأمر وهو تنويع يفتح هذه الإمكانية بطبيعة الحال.
لقد كان أصحاب نظرية الخلق من عدم، كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والفيلسوف الكندي والإسماعيلية هم الأقرب إلى نظرية الأمر الإلهي والقضاء الإلهي في إيجاد الأشياء الفوري، بينما كان آخرون كابن رشد وابن عربي وابن تيمية يلتزمون الكيفية الأخرى بالخلق التي تفهم العالم على أنه استمرار دائم من الكون والفساد بلا بداية ولانهاية، بوصف هذا الموقف هو تأويل الخلق التدريجي الذي تحدث عنه القرآن. ومرة أخرى نلاحظ أن الممارسة الفكرية للمسلمين كانت كلها تأخذ بالتأويل، وكلها تقدم صيغاً عن الخلق مختلفة عن الحرفية القرآنية ولكنها مستوحاة من النص ومايفتحه من إمكانات تفسيرية، في الوقت الذي يتم فهم التعبيرات القرآنية عن كيفية الخلق فهماً رمزياً. إن خلق الله للإنسان وللأنعام بيديه هو مسألة رمزية عن الفعل الإلهي، وعن دخول الله في علاقة فعلية مع العالم.
النمط الثالث من التأويل: الله والأمثلة المقاربة له
في شكل آخر من علاقة اللغة الرمزية بموضوعها نجد أن اللغة الرمزية لاتحيل على موضوعها من أجل ضبطه بل من أجل مقاربته فقط لأن هذا الموضوع يقع أصلاً خارج إمكان التعيين اللغوي التام. هنا يصبح التأويل جهداً إدراكياً مفتوحاً يقوم به الإنسان بدافع طموحه لأن ينتقل من اللغة الرمزية إلى تصور الموضوع الذي تقصده هذه اللغة، وفي هذا الجهد تنفتح إمكانات اللغة الرمزية على تأويلات متعددة يصعب حصرها في شكل محدد. إن التأويل هنا هو توقع المقصود الذي تحيل إليه اللغة الرمزية دون الإدعاء أن هذا التصور هو المطابق بدقة لما تعنيه تلك اللغة. وغالباً مايتم تأويل اللغة الرمزية في سياق البحث عن مقصودها من خلال قرائن أخرى مساعدة تُعين على مقاربة هذا المقصود. والمثال الأبرز في هذا النوع التعبيري الذي يستدعي التأويل هو مايسميه القرآن: “الأمثال” التي يضربها الله للناس كي يفهموا ويقاربوا. ولعل أبرز مثال عن هذا النوع من التعبير الرمزي المشتق من الأمثال هو الآية التي تصور الله بالنور: “الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم” (النور: 35)
إن الله ووضعيته الكونية وصلته بالعالم يقدمها القرآن في صيغ رمزية، الأمر الذي يعني أن الله الذي وصف نفسه رمزياً يبيح للإنسان بكل تأكيد أن يذهب في فهمه له إلى ماوراء الصيغ المباشرة والتقريرية.
إن التنزيه الإلهي نجده هنا في هذا النوع الرمزي من التأويل، فالله غير القابل للتعين النهائي يمكن لنا مقاربته بلغة رمزية، وأحياناً غير رمزية، ترضي قليلاً من طموحنا المعرفي وتساعدنا على بناء عالمنا، ومن جهة أخرى تثير فينا كل أنواع الشكوك على مدى بلوغنا الحقيقة كما هي. هنا ينفتح الفكر الإسلامي على كل محاولة لمقاربة الله، الذي بقدر مانقترب منه من خلال لغتنا بقدر ما نعرف أنه بعيد عنها، الأمر الذي يحثنا على محاولة جديدة في بناء تصور لغوي آخر. إنه الاختلاف الذي لاينتهي بين إله منزه عن كل شيء وبين جهدنا العقلي كبشر من أجل ملامسة الحقيقة.
عبد الحكيم أجهر
Ph.D في الدراسات الإسلامية من جامعة ميغيل، مونتريال، كندا
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، الإمارات العربية المتحدة
_______________
الهوامش
الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (بيروت: دار المعرفة، 2002) ص. 625.
ابن كثير القرشي الدمشقي، أبو الفداء اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار ابن حزم، 2000) ص. 1163، & الطبري، جامع البيان، ج. 15، ص. 313.
الرازي، التفسير الكبير، ج. 7، ص. 485.
الطبري، جامع البيان، ج. 15، ص. 320.
الرازي، التفسير الكبير، ج. 7، ص. 489-90.
ابن عربي، تفسير ابن عربي، 2 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001) ج. 1، ص. 229.
سابق، ص. 256.